
كتب جورج برنانوس عام ١٩٤٦ في كتابه الشهير "فرنسا ضد الروبوتات": "لا نفهم شيئًا عن الحضارة الحديثة إن لم نعترف أولًا بأنها مؤامرة عالمية ضد كل أشكال الحياة الداخلية". وقد انتشرت هذه العبارة على نطاق واسع حتى أصبحت لازمة. وبعد ثمانين عامًا من نشر الكتاب، لم يفقد الكتاب أيًا من أهميته. فهو يشكك في أسلوب حياتنا، لأنه إذا رأينا أشكال الحياة الداخلية المختلفة تتراجع، تحت وطأة العلوم التقنية التي تنتزع جميع الحقوق من جميع الكائنات، يصعب علينا معرفة ما يدفع هذه العملية ويجعلها حتمية. فهل يمكننا أن نلجأ إلى حياتنا الداخلية، ونتصرف كمتمردين على هذا العالم الذي لا يحب سوى الظواهر الخارجية وتدفقات عواطفه التي تُدفع إلى ذروتها، والتي تُشوه الحياة لتجعلها جميعًا متشابهة ومُظلمة.
في هذه الأيام، تتلاشى الحياة في دوامة المشاعر. لا سبيل آخر لها. المشاعر هي التي تحكم العالم. علينا أن ندعها تتكشف، ننتظرها، نحملها، نفهمها، نستحوذ عليها، نحترمها، ونطلق لها العنان. نعيش في ظل سيطرة المشاعر، التي تفرض نفسها كحقيقة وحيدة للإنسان. الخبراء، الذين أصبحوا حاضرين في كل مكان هذه الأيام، يشجعوننا على المضي في هذا الاتجاه. "هذا جيد لك! يجب أن تتحرر من هذه القيود! يجب أن تجد الهدوء وسط العواصف التي تهيّجك، دع مشاعرك تعبّر عن نفسها..." من الشائع هذه الأيام رؤية الأعراض فقط دون إجراء التشخيص الصحيح. هذا يُلامس خصوصية المجتمعات المنهكة، المُرهقة من نفسها، التي لن تعرف أبدًا كيف تُصلح نفسها؛ لم تعد تعرف كيف تُسائل نفسها. هذا سيُبالغون في تقديرها. يُخفّفون من شأن المعايير لأنهم يفتقرون إلى الشجاعة. لقد أنارتنا البشائر بهذا المعنى، وكان علينا أن نتكيف: لم يعد القديسون موجودين! هل كانوا موجودين حقًا؟ الأشخاص الحريصون على القيم، والمتعلمون، والشرفاء (الذين يجعل استحضارهم البُوْبو يبتسمون 1 ) كانوا أيضًا مخطئين. لقد طاردنا جثة الرجل الصادق. لقد وجدنا بعضًا ممن لم يكونوا صادقين، ولذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الصدق لا يجلب شيئًا لأنه لم يعد بإمكان المرء أن يكون صادقًا أو أن يكون أقل صدقًا، وأن هذا المثال لا يمكن أن يدفع الناس إلا إلى الضلال. القدوة، في العار! لكل هذه الأسباب، تقرر أنه يتعين علينا رفض إملاءات التعليم واللياقة... لقد فتحنا المجال أمام اللامبالاة والفردية والجماعية... كان معلم السبعينيات يعرف ذلك: في فصله، إذا كان هناك طالب مشاغب، فيجب احتواؤه، لأنه كان يقود الآخرين معه. ما نراه كأطفال يشكلنا. كلنا نعرف أشخاصًا أثاروا إعجابنا عندما كنا صغارًا. لأنهم تجرأوا أكثر منا، ولأنهم تحدثوا بصوت أعلى، فإن التواجد حولهم منحنا شعورًا بالحرية. تركنا أنفسنا نستسلم لعواطفنا، التي بدت لنا أقوى حساسات كياننا الداخلي، وتحملنا نوعًا من الإدمان على هؤلاء الأشخاص الذين أبهرونا، الذين سمحوا لأنفسهم بما لم نكن نتخيله ممكنًا... المثال السيئ يُلوث القطيع. ما نراه يُنشئنا. تحدث كلوديل عن "العين المُنصتة". جميع الحواس مُتيقظة في عالم يُطلق العنان لها. حواسنا تبحث بيأس عن المعنى! ينهار إيماننا، ويغرق عالمنا، كوننا، في مستنقع. نبدأ بالإيمان بالمستحيل. نُصرّ على الخطأ، ونسعى إلى نوع من الرومانسية، عندما تُخنق المشاعر الروح وتُعلن الأرواح وحدتها في صمتٍ مُطبق.

ماذا شعر جورج برنانوس عندما كتب مقاله النبوي وهذه الجملة المروعة التي يتهم فيها العالم الحديث بالتآمر للقضاء على الحياة الداخلية؟ ماذا يقصد الكاتب بـ "الحياة الداخلية"؟ الصمت، بلا شك. الحرية، رمزها أيضًا. كل ما يعارض ضجيج العالم المحيط، الذي غالبًا ما يكون عديم الفائدة. يستحضر برنانوس عالمًا حميمًا وثمينًا، حيث تُصقل الطبيعة والثقافة وتشحذ خصوصية كل شخص. ليس الأمر متعلقًا بتقييد المشاعر التي تفتح بابًا على الروح، وحرمان أنفسنا منها سيحرمنا جزءًا من إنسانيتنا. في الماضي، علّمنا التعليم غربلة مشاعرنا واكتشاف تلك التي تستحق العناء، تلك التي تُقوي الروح وتتيح لها لقاء أرواح أخرى. هذه هي الفكرة الأساسية: أن نعرف أنفسنا لنعرف الآخرين بشكل أفضل. "وهكذا نجد في اللباقة ثلاثة أنواع من العناصر التي لم تغفلوا عن تمييزها: الأعراف التي يجب معرفتها واحترامها باسم العادة وحدها؛ والأعراف النفسية القائمة على مشاعرنا الطبيعية وعلاقاتنا؛ وأخيرًا، الفضائل الأخلاقية التي تتخلل الأخلاق الحميدة وتمنحها أسمى معانيها"، كتب الأب الموقر أنطونين-دالماس سيرتيلانج عام ١٩٣٤. وأضاف أن اللباقة "الشكلية البحتة" أثبتت أنها لا قيمة لها: "اللباقة الحقيقية شيء مختلف تمامًا؛ إنها مبنية على الأخلاق، وفي حضارة كحضارتنا، نابعة من الإنجيل، فهي مبنية على الأخلاق المسيحية". هذا يُحدد بدقة الهدف العميق للتربية: نقل ما نُقل وجعله محبوبًا. تابع الأب سيرتيلانجي حديثه بهدف إعادة توحيد السماء والأرض: "القديس الحقيقي لا بد أن يكون مهذبًا، لأنه فاضل وحكيم؛ لأنه يشعر بالآخرين ويحترم نفسه. أما ما وراء الطبيعة، إذ يلتصق بالطبيعة، فيرغب في كمالها. وهي تُكملها بنفسها". كل هذه الأخلاق، علم التمييز والإرادة، يضع مثالًا أسمى للشباب بتقييده الطريق الذي يجب اتباعه. ترأست السلطة هنا (٣) : فقد أثبتت فائدتها في "تنشئة" الشاب. وقد قدمت قصيدة روديارد كبلينج (٤) صورة شعرية لهذا. علم لم يُعلن عن نفسه كذلك، استخدم العواطف كوسيلة لا غاية للوصول إلى الروح وإصلاحها كل يوم من أيام الحياة، وهي القضية الحقيقية الوحيدة. لقد تغير عالمنا كثيرًا. لكن هل تنبأت هذه الحضارة الحديثة التي يُعرّفها برنانوس بدقة أنها لن تبقى حضارة حقيقية؟ عندما تخلت عن النقل وبدأت في خنق الحياة الداخلية في مهدها. هذه الحضارة تساءلت، وشككت، ماذا تريد أن تقول بعد حربين عالميتين؟ لو لم تحمينا القيم الأخلاقية من التصرف كالحيوانات، فمن سيحمينا؟ كان علينا أن نفكر بطريقة مختلفة، وأن ندرك أن الحرب كانت موجودة دائمًا، وأنها وُلدت من أناسٍ يفتقرون إلى القيم الأخلاقية أو شوهوها، وأن قيمنا الأخلاقية هي التي سمحت لنا بالنجاة من هذا الجحيم. فهل لم تحمينا تعليمنا، وأدبنا، وقيمنا الأخلاقية من المصاعب والعار؟ لأننا، بالفعل!، حلمنا بعالم خالٍ من المصاعب والعار! في نهاية القرن العشرين، هتف مغنٍّ فرنسي: "من أجل المتعة!"، راغبًا في حمل الجماهير معه! سيطر اللذة على الساحة، وتحت أنغامها الملائكية محت كل ما كان موجودًا. وهكذا، فُتح عهد النسبية. كل شيء يستحق كل هذا العناء، لأن ما بُيع لنا على أنه خير مطلق قد فشل دائمًا. تشابك الخير والشر في رقصة محمومة. الفضائل الأخلاقية ترفع الروح، والمتعة تخنق القيم، وتثنيها، وتطمس الحدود، وتمنع النمو في النهاية. إن نسيان غرض الأشياء يمجد أصل فقدان المعنى. بدون الخير والشر، هذا الشعور اللذيذ بأنه لم يعد هناك محظورات، وأن كل شيء مسموح به، وأننا مثل الآلهة، أحرار. هذا الشعور بالحرية الذي ليس حرية، ولكنه يسكر، يسكر... هذا الشعور بالحرية الذي هو في الواقع قوة فقط، بقايا قوة. فرض ملك المتعة قانونه، وعدالته، وتقليده... شيئًا فشيئًا، حول الجميع إلى الجميع دون أن يلاحظ أحد. بحجة السماح للجميع بالعيش في حياتهم، أجبرنا على أن نصبح صهارة غير متمايزة. بحجة القضاء على صناديق الخراطيش القديمة هذه التي غلفت مستقبلنا، خلقنا مستجدات مذهلة وعديمة الفائدة. انقلاب كامل للقيم. سمحت لنا الحضارة بتحقيق الإنجاز من خلال طاعة القواعد المشتركة وثقافة مشتركة؛ دشّنت الحضارة الجديدة شكلاً جديدًا من أشكال الحياة، حيث لم يعد الخير والشر يُعرّفان مُسبقًا، ولم يعد يُعبّران عن حقيقة الفعل. لم يرَ جورج برنانوس هذا الدوار الحضاري يلوح في الأفق، ولكن كعادته، حثّه حدسه الاستثنائي على التنديد بفقدان الحياة الداخلية، الذي هاجمه وأساء إليه، والذي قد يكون مُميتًا. لأن زوال القليل من الإنسانية لا يُبشّر بالخير. يرى الكاثوليكي العالم بمنظور فريد. من خلال علاقته الحميمة بيسوع المسيح، يُدرك طموح الله له. هذه الخصوصية تمنحه الشرعية لامتلاك العالم وامتلاكه. تتجسد القوة التي تمنحها الحقيقة في أولئك الذين يدّعونها.

التعليم، والأخلاق الحميدة، والأناقة (التي لا ترتبط بترف الملابس)، والاهتمام بعالم المرء، كلها صفاتٌ موجودة في الفرنسي حتى وقت قريب، بضعة عقود على الأكثر. وكما قال الأب سيرتيلانج، كان الأمر يتعلق بـ"بناء" رجال قادرين على بثّ القيم الأخلاقية المسيحية. استمرت هذه القيم أو الفضائل الأخلاقية لفترة طويلة بعد الحركات المعادية للكاثوليكية الكبرى التي ضربت هذا البلد. حتى بدون الله، نمت هذه الفضائل الأخلاقية على أرض كاثوليكية ولم تستطع الفرار منها. لكنها الآن، كدجاجة بلا رأس، تركض في كل اتجاه ودون هدف. حتى ذلك الحين، كان يُعالج ما حدث من أخطاء بالتقاليد والتجربة؛ وكان يُقرر أن التجديد وحده هو ما يُحدث التحسن. التقدم، تلك الأسطورة المعاصرة العظيمة، وجد هنا وقودًا غير متوقع وغير قابل للتصرف. حداثة دائمة لا تعرف الكلل تحملها الإعلانات لجماهير من الأفراد الذين يرغبون جميعًا في الشيء نفسه أو أحد أشكاله. التقدم العظيم!، الذي حلم به الاشتراكيون والرأسماليون، وجد أساس مشروعه في الاستهلاكية الأكثر عبثية! بفقداننا القيم الأخلاقية، فقدنا الروح، لأننا لم نعد نُقدّرها، بل تجنبناها، حتى أننا لم نعد نتحدث عنها، فقد ذبلت ولم تعد تُعطي أي أثر للحياة. ولأن الجميع تصرفوا بنفس الطريقة، ساد الاعتقاد بأن من الجيد التصرف بهذه الطريقة. أدت الفردية إلى تقليد جامح. ألزمت القيم الأخلاقية الجميع بفهم وتقدير والتكيف مع بعضهم البعض؛ وضعنا أنفسنا مكان الكبار، مما أجبرنا على التواضع؛ وفي هذا النسب، وجد كلٌّ مكانه بتميزه، الذي نابع من تجذر. الآن، نعتقد أننا "نخترع" حياتنا. لم يبقَ سوى التجديد، على الأقل ما نُطلق عليه هذا الوصف، مدركين أنه لا توجد أفكار جديدة كثيرة على الأرض، بل وسائل جديدة لأفكار قديمة. لا يزال يتم تجاهل الروح، وكذلك التفرد الذي يُمثل حزام نقلها. تفرض الشبكات الاجتماعية قواعد أكثر تقييدًا من الفضائل الأخلاقية القديمة، ويسارع الجميع إلى تبنيها لأنها جديدة، وتجددها المستمر يجعلها أكثر جاذبية. الفردانية هناك تنشر قواعد ومواقف لا تستند إلى أي حقيقة، بل تنتشر بسرعة الضوء وتجد حقيقتها في عدد أتباعها، ونحن لا نتبعهم من أجل حقيقتهم مرة أخرى، ولكن للانتماء إلى مجتمع. هذا السلوك أصبح معتادًا، لا يتسامح الجيل Z مع أدنى انتقاد، ولا يصلح إلا إذا قرر ذلك، ويغضب من نعم أو لا، ويؤسس للتسويف كفن للعيش ... وبالتالي، يجب على المرء أن يشكو من أجل الوجود. النرجسية تلقي حجابًا جديدًا على الواقع. الضحية تحل محل البطل، نتاج النظام الأبوي. أصبح المنع ممنوعًا بشكل متزايد. يُعتبر العديد من القديسين معذبين هذه الأيام، لأنهم أجبروا الناس على الذهاب إلى حيث رفضوا الذهاب. عندما نقول لك أن القديسين لم يعودوا موجودين! يُعرّف الفيلسوف الأرثوذكسي برتراند فيرجيلي هذه الصدمة قائلاً: "يحتاج هذا الجيل إلى الاعتماد على الأساسيات، ولكن هذه الأساسيات لم تُحترم. فالأسس التي يعتمدون عليها غير واضحة، وهذا يُولّد الخوف".
ليس من الصعب فهم أن التقليد يُدمر الحرية بإحلاله محلّ الإرادة الحرة حسن نية المؤثرين الذين لم يُثبت استقلالهم بعد. فبدون الحرية، سينعدم الحب قريبًا. إنه يتلاشى بالفعل. لا يزال يُسمع في أفواه الرجال والنساء، لكنه لم يعد ينبض، ولم يعد يتلألأ، بل يتسطح، وينكمش... وككثير من الكلمات التي استخدمتها الحضارة الحديثة، سينتهي به الأمر إلى قول عكس المعنى الذي أعطاه له البشر على مر القرون. سيصبح التحكم في العواطف مفتاح كل سياسة بدلًا من الصالح العام. ستمضي الحضارة الحديثة كما عرفت منذ زمن: ستدفع الناس إلى التعبير عن مشاعرهم، والكشف عن أنفسهم، من أجل تقييدهم وإيذائهم. سنتحكم في العواطف بتحديد ما يستحق أن يكون مرغوبًا فيه. نحن بالفعل نتحكم في الرغبات الاستهلاكية بخلق أشياء عديمة الفائدة أو عديمة الفائدة. سيبتلع المقتلعون من جذورهم كل ما يُعرض عليهم، إذ لم تعد أي ثقافة تقليدية تتحدى أذواقهم. هذا المجتمع، الذي لا يحمل على شفتيه سوى كلمة "التنوع"، يراقب دون أن يتفاعل اختفاء ما يقرب من نصف اللغات المحكية في العالم، ويسمع اللغة الفرنسية التي تُتحدث اليوم في ساحات المدارس وحتى الجامعات تبدو أقرب إلى لغة مبسطة منها إلى لغة أصلية. لا يكترث، بل يستخدم الكلمات كأدوات إعلانية، كلمة مقابل أخرى، كلمة مقابل أي كلمة أخرى. الكلمات، كأي شيء آخر، يجب أن تصبح أحدث من أي وقت مضى. لا شيء ثابت. كل شيء مائع. لم يعد لدينا الوقت للتعود عليها، ناهيك عن ترسيخها، لأن السرعة والحداثة هما السائدان. اعتبر الأب ريجينالد غاريغو لاغرانج، الذي يعتبره البعض أحد أعظم علماء اللاهوت في القرن العشرين، أن الفضائل الأخلاقية هي ميول مستقرة ومألوفة توجه الإنسان نحو الخير في أفعاله اليومية. لقد أثرت هذه الفضائل القدرات البشرية لتمكينها من التصرف وفقًا للعقل المستنير بالإيمان. هذه الفضائل: الحكمة، والعدل، والصبر، والاعتدال، بممارستها، وما تفرضه من انضباط، وما تقدمه من فرح، أشبعت النفس، فتقوى، وصار لها معلم في محن الحياة. بالنسبة للدومينيكي، لا يمكن تصور الفضائل الأخلاقية إلا بدعم من الفضائل اللاهوتية. عون الله في الشدائد، والشكر الموجه إليه في نشوة الفترات السعيدة، يرتكزان على هذه الفضائل الأخلاقية، التي ترتكز على الفضائل اللاهوتية.
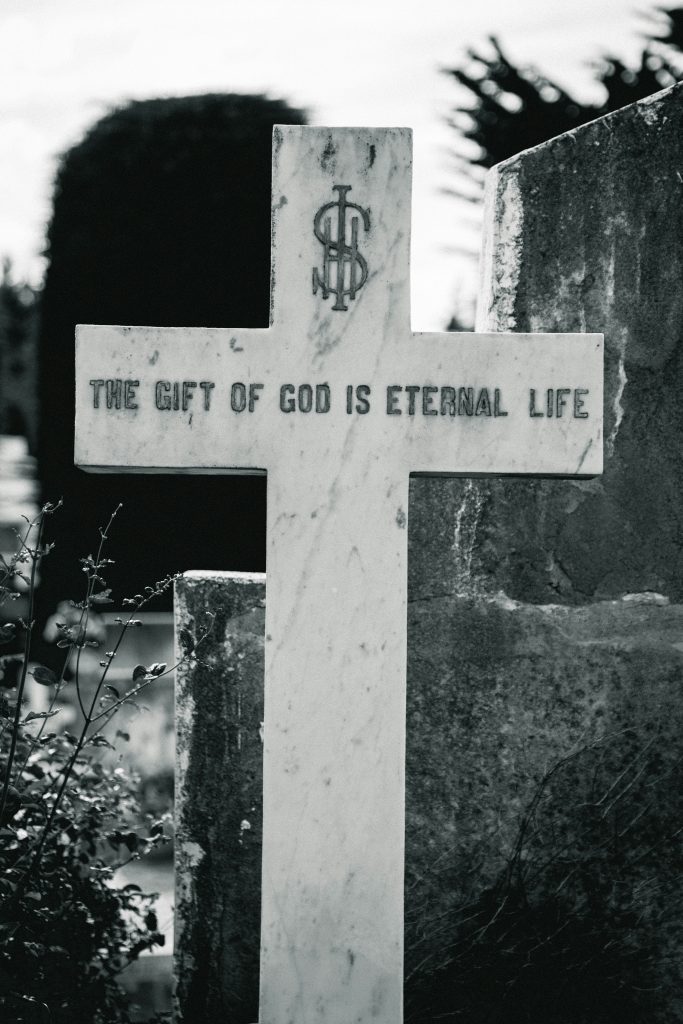
الموت الحقيقي للروح يحدث عندما نعيش على سطح ذواتنا. فالأحمق أو الفقير المثقل بالقيم الأخلاقية ليس أحمق ولا فقيرًا عشر ، نوعين من العواصف الأخلاقية: "تأتي هذه العواصف أحيانًا من الخارج، وأحيانًا من الداخل. عواصف من الخارج: هي الشؤون التي تشغلنا، والنكسات التي تغمرنا، والأمثلة السيئة التي تهزنا، وتناقض الألسنة، وصراع الإرادات والشخصيات، والحرج من كل نوع. عواصف من الداخل: هي الأهواء، والكبرياء، والشهوة، والجشع، التي تدمر النفوس دون أن تشعر؛ والحواس التي تثور، والرغبات التي تعذبنا، والخيال الذي ينفلت من عقاله، والعقل الذي يضيع في أفكار لا طائل منها، ومخاوف وهمية، وآمال باطلة". يتطلب تعلم التعمق في أعمق رغبات المرء ممارسة مستمرة تمنعه من ارتكاب الأخطاء، لكن الخبرة المكتسبة ستُعزيه عن الفشل وتسمح له باستعادة توازنه. في عالم ينبض بإيقاع الإدمان الذي يخلقه باستمرار، والذي يستخدم الفضائل لعكسها، مما يُغيّر معنى الكلمات فتُفرغ من جوهرها، من المهم أن نبقى "مستيقظين" (لا ينبغي الخلط بينه وبين الانحراف المُستيقظ، وهو دليل جديد على ما أسماه تشيسترتون "الفضائل المسيحية المُختلّة"). لدينا بابٌ لروحنا نفتحه أو نغلقه بإرادتنا الحرة. "ما الذي يُولّد هذا الجشع وهذا العجز فينا إذن، إن لم يكن في الإنسان سعادة حقيقية، لم يعد يملك الآن سوى أثرها الفارغ تمامًا، والتي يحاول عبثًا أن يملأها بكل ما حوله، باحثًا عن العون من الغائبين، وهو ما لا يحصل عليه من الحاضر، بل كل شيء عاجز عنه، لأن هذه الهاوية اللانهائية لا يمكن ملؤها إلا بجوهر لا متناهي وثابت، أي بالله نفسه 6. " هذا الفضاء اللانهائي موجود فينا، ويجب أن نخوض فيه. ما فائدة مراقبة الكون إذا لم نتذوق حياتنا الداخلية أبدًا؟ هناك حيث نعرف أنفسنا حقًا 7. لا يمكن لأحد أن ينساه بمجرد وجوده هناك. إنه من واجبنا أن نُظهر هذه اللانهائية لتنبت في كل إنسان. علينا ألا نبحث عن ما يكمن في داخلنا خارجًا. إن كان لا بد لنا من أن نعيش، فعلينا أن نعيش كمتمردين، إذ يجب علينا دائمًا أن نراقب هذا العالم بحذر، الذي يُثير فينا شغفًا بالضوضاء والابتذال. ولضمان عدم تحقق خوف برنانوس، لا بد من إعادة اكتشاف الفضائل الأخلاقية. ألا نغرق في بحر حياتنا.
- خلال هذا البرنامج الذي يُبث على إذاعة فرنسا الدولية، نشعر بالحيرة: هل المثقفون المدعوون هنا منعزلون عن الواقع أم أنهم مجرد أيديولوجيين؟ نشفق على هؤلاء الذين لم يلتقوا برجل نزيه في حياتهم. يا لفقرهم وفظاظتهم! https://youtu.be/6WJbxEOYqQE ↩
- أخلاق جيدة حقيقية. الدليل الرائد في Belle Epoque: وجهات نظر القرن الماضي حول الأدب والأخلاق الجيدة من قبل إخوة المدارس المسيحية. طبعات الرجل الصادق. ↩
- انظر هذه المقالات عن السلطة: لماذا هذه الكراهية للسلطة؟ وعن السلطة ↩
- قصيدة إذا. ↩
- لقد أدرك بودلير العظيم هذا الأمر تمامًا في قصيدته الرائعة "إنيفريز-فو" . سيقدم سيرج ريجياني تفسيرًا بديعًا لها ، ولكن بصفتنا من أبناء فترة ما بين الحربين العالميتين، نشعر بالفعل أن الفضائل وحدها هي التي أصابته بخيبة الأمل، وأنه لا يفهم سبب تعلق الشاعر بها إلى هذا الحد. كان عليه أن يسأل نفسه: لكي يُقرّ رجل مثل بودلير الفضيلة على أنها تعادل مخدراته المعتادة - النبيذ والشعر - لا بد أنه مارس الفضيلة كثيرًا ورأى فيها عظمة لا تقل عن عظمة مخدراته المفضلة .
- بليز باسكال. شظية السيادة حسناً N ° 2/2 ↩
- القديس أوغسطينوس (354-430). عن مجيء المسيح، العظة ١٩. "أيها الإخوة، أسمعُ شخصًا يتذمر على الله اليوم: "يا رب، ما أصعب الأوقات! ما أصعبها!"... أيها الإنسان الذي لا يُصحِّح نفسه، ألستَ أقسى ألف مرة من الزمن الذي نعيشه؟ أنتَ الذي تتوق إلى الترف، إلى ما هو مجرد غرور، أنتَ الذي لا يشبع جشعه أبدًا، أنتَ الذي تُريد إساءة استخدام ما تشتهيه، لن تحصل على شيء... فلنُصحِّح أنفسنا يا إخوتي! فلنُصحِّح أنفسنا! الرب قادم. لأنه لم يظهر بعد، يسخر الناس منه؛ ومع ذلك سيأتي قريبًا، وحينها لن يكون وقت السخرية منه بعد. أيها الإخوة، فلنُصحِّح أنفسنا! سيأتي وقت أفضل، ولكن ليس لمن يعيشون حياةً سيئة. العالم يشيخ بالفعل، ويتجه نحو الخَرَف؛ ونحن، هل سنعود شبابًا من جديد؟ ماذا نرجو إذًا؟ أيها الإخوة، دعونا لا نأمل بعد الآن في أوقات أخرى غير تلك التي يُحدِّثنا عنها الإنجيل. إنها ليست سيئة لأن المسيح هو قادم! إن بدت لنا صعبة، يصعب تجاوزها، يأتي المسيح ليعزينا... يا إخوتي، لا بد أن تكون الأوقات صعبة. لماذا؟ حتى لا نبحث عن السعادة في هذا العالم. هذا هو علاجنا: يجب أن تكون هذه الحياة مضطربة، حتى نلتصق بالحياة الأخرى. كيف؟ اسمعوا... يرى الله الناس يكافحون بشقاء تحت وطأة رغباتهم وهموم هذا العالم التي تقتل أرواحهم؛ فيأتيهم الرب كطبيب يُعطيهم الدواء. ↩

اترك تعليقاً